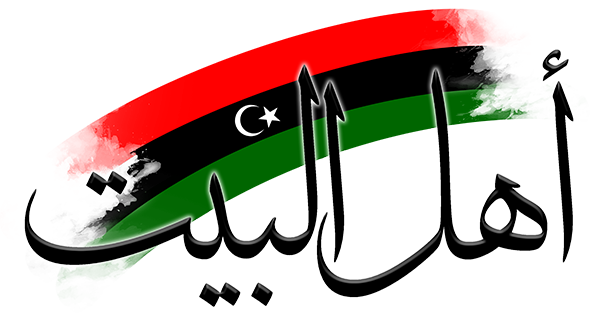السلفية… أيديولوجيا التشرنق في الماضي التعيس

تقوم السلفية على الإيمان بمطلقيّة وثبات منظومة الفكر التراثي الماضويّة، العائدة في أصولها الفكرية الاعتقادية إلى القرن الأول الهجري، بمعزل عن سياقاتها التاريخية، وبمعزل عن واقع تغير الأزمنة و اختلاف الأمكنة، ودون تمييز أو مراجعة نقدية لما يتصل منها بظروف الزمانوالمكان، من امتداد تأثير حمولات الإرث الحضاريوالذاكرة التاريخية للجماعات والشعوب، فالسلفي هو شخص منتزع من ذاته، يعيش بيولوجيّاً في الحاضر المتعين، بعقلية الماضي البعيد، تستغرقه قطيعة تامة مع تحولات الواقع، المتدفق تجاوزا للراهن، منطويا على إيمانية غيبية استعلائية، تفترض في نفسها الاحتواء على يقينيّةِ الحقيقة ونهائيّةِ المعرفة واكتمال العقل وخلاصة تطور حركة التاريخ. والسلفيّ يرى فيما أجمع عليه السلف، الامتلاء الكليّ والكمال المطلق، وهو كمالٌ تحقق في الماضي (المجيد) مرة واحدة وإلى الأبد. ويرى في معطيات الماضي، من المعتقداتِ ميثيةِ الجذور، والتراث التديّني والتمذهبي، حقائقَ أزليةً أبدية ثابتة، غير قابلة للمراجعة والنقض.
لكن ما الذي يدفع بالإنسان العادي إلى الاعتصام بالماضي، مُوَليّا ظهره للحاضر، سواء في حركة استسلام يائس، تعبر عن نفسها في الانكفاء على الذات، والانسحاب إلى الظل، والزهد، والدروشة، تحت لسع سياط الشعور بالذنب والتخويف من العذاب وعقاب الشوي في النار، تماهيا مع النصوص الدينية، التي تزين (للفقراء) الانصراف عن طلب نعيم الدنيا (الزائل)، والتعلق الخرافيّ بطلب مُتع (الحياة) الآخرة، التي لا تزول! أم في شكل تَمثّل عقَديّ لتراث ونصوص الكراهية والتكفير، مع جنوح حاد إلى العنف (الجهادي) التعويضي، الموجه ضد الآخر المختلف: الكافر.. المرتد، استهدافا له بالإلغاء المعنوي أوالمادي، اقتداء بسيرة السلف (الصالح)؟
تُمِدنا المتابعة الاستقرائية للأحداث المغطاة إعلاميا بالخبر والصورة، والموثقة مِهنيا بتقارير الصحافة الاستقصائية وتقارير المنظمات الحقوقية، حول ممارسات التنظيمات السلفية الجهادية، كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بنفس الاستنتاجات والمؤشرات التي نستمدها من رصد وتحليل الأحداث اليومية لممارسات الجماعات السلفية – بمختلف أسمائها الحركية ورؤاها الفكرانية – المنتظمة في التشكيلات شبه العسكرية (الميليشيات) بليبيا، لتتقاطع المحصلة في التحليل الأخير، مع النتائج التي خلصت إليها بحوث علم الاجتماع ودراسات علم النفس الاجتماعي، مِن أنّ ظاهرة المد السلفي، هي في أحد أبرز أسسها، انعكاسٌ لاختلالٍ يعصف ببنية المجتمع، فيؤدي إلى انفصال الإنسان عن النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، كما يرى إيرِك فروم (1)، ذلك أن إنسان اليوم يعيش غريبا عن عمله، وسواء كان عاملا أو موظفا أو مديرا لشركة، فهو مغرّب عن ذاته، يركع أمام أصنام من منتجات يده، فاقدا للسيطرة على مصيره، في مجتمع استهلاكي قوامه أناس جبناء خائفون.
ومع شعور الإنسان بالاغتراب الذاتي إزاء أوضاع اجتماعية، لم تكن يوما بالنسبة إليه، أسوأ مما هي كائنة عليه، نتيجة لما يسميه ماركس اغتراب العمل، كشكل من أشكال الاغتراب، حينما ينفصل الإنسان عن ناتج عمله في اقتصاد السوق، فلا يسيطر عليه فقط إنسان آخر، وإنما أيضا قوى أخرى غير إنسانية، هي مجموعة القوانين التي تحكم راس المال والسوق (2)، على نحو يؤدي إلى إسهام ناتج عمل الإنسان في قهره، داخل أطر العلاقة غير المتوازنة وغير المتكافئة، بين رب العمل والمستخدَمين الأُجَراء – أي بين الأعلى والأدنى – في الترتيب الهرمي لمجتمع النظام الراسمالي، بما هو مجتمع طبقي اضطهادي واستبدادي، ولا عقلاني في منطقه الداخلي، فيما يسميه هربرت ماركوز الطابع العقلاني للّاعقلانية (3)، حيث يتمثل جانب من لاعقلانية المجتمع الراسمالي المتقدم صناعيا، في تمويه انقسامه الطبقي، بالترويج لثقافة الاستهلاك، كأن يقتني العامل – بكل حرية – نفس الموبايل الذي يقتنيه رب العمل، وذلك بواسطة تزييف الحاجات، ومن ثم تلبية تلك الحاجات الزائفة، في سياق الوظيفة الاضطهادية لمجتمع الوفرة، الذي تغدو فيه الحريةُ المنظمة أداةَ سيطرة واستعباد، كحرية المنافسة في أسعار مقررة سلفا، وحرية صحافة تمارس الرقابة الذاتية.. المحكومة بهوى المموِّل، وحرية الاختيار بين نفس أنواع السلع والمنتجات، مختلفة العلامات التجارية، المخصصة للاستهلاك، وصولا إلى إحكام السيطرة على جماهير المستهلكين – وهم في أغلبيتهم مستخدَمون أجراء – باستنزاف مداخيلهم المحدودة والتحكم بحياتهم، واستعبادهم أيديولوجيا بوهم الحرية (الليبرالية)، حيث إن عبودية اليوم – وفقا لماركوز- لا تتحدد فقط بالكدح والطاعة، بل أيضا بتشيُّءِ الإنسان، وبما تصنعه المنتجات من وعي زائف لا يعي زيفه، فقدرة الإنسان على اختيار سادته، لا تلغي وجود السادة والعبيد، اللهم إلا أن يجوز للعبد، أن يتوهم أنه حر، لمجرد أنه حصل على الحرية في اختيار سادته!
على أن العلاقات الاضطهادية في المجتمع الراسمالي (الصناعي) المتقدم، لابد من أن تؤدي إلى تبلور وعيٍ متقدم لدى الطبقة العاملة، هو بطبيعة تكوّنه وعي ثوري – رغم كل محاولات تزييف الوعي – يَنتُج عنه ظهور وتنامي حركات نضالية، لتجاوز أوضاع القهر الطبقي الذي تتعرض له الطبقة العمالية، فتنطلق حملات احتجاجية مناهضة للاستغلال الراسمالي، كأنْ يُشن إضراب عام، يوقف عمليات الإنتاج في المصانع، ويشل الحياة في جسد النظام، إلى أن تتحقق للعمال والمعطلين عن العمل مطالبهم المُحقّة. ومِن قبيل ذلك ما جرى سنة 2011 بأميركا، بتنظيم حركة (احتلوا وول ستريت /Occupy Wall Street movement)، احتجاجا ضد البطالة، واعتراضا على خطط دعم القطاع الخاص على حساب المواطن العادي، حتى إن المرشحيْن للانتخابات الرئاسية هيرمان كير ونيت غينغريش، وصفا الحركة بأنها “صراع طبقي”، حيث بدأت في نيويورك، وامتدت منها إلى باقي الولايات والمدن، ومن شعاراتها: “العامل المشترك الذي يجمع بيننا، هو أننا نمثل 99 %، ولن نتسامح مع جشع وفساد الـ 1 %”، وانتقلت من أميركا لتشمل 25 دولة راسمالية حول العالم، ما اضطر إدارة باراك أوباما إلى فضها بالقوة الغاشمة واعتقال المئات من شباب الحركة، مع تعهد بالعمل على معالجة الأوضاع المعيشية المتردية للأغلبية الشعبية.
أما في المجتمع المتخلف، حيث تسود القيم السلفية كأيديولوجيا شمولية ماورائية، تستمد قوتها التأثيرية على عقول العامة، من الانتساب إلى الذات الإلهية (العليّ القدير)، يأخذ اغتراب الذات الإنسانية أشد أشكاله لاعقلانية، في علاقة الاضطهاد والاستبداد التوتاليتاري (الكُليّ)، من خلال هيمنة أقلية اجتماعية – بما اكتسبته من امتيازات طبقية – على الثروة والسلطة، معزَّزة بالمقدس، تفرض على الأغلبية وضعيةً دونية، تنتزع الإنسان المقهور من إنسانيته، وتحيله إلى كائن آليّ (روبوتيّ)، مستلب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا، فإن الإنسان المقهور يجد نفسه أسير مأزق وجودي، مجرّدا من القدرة على الفعل، فاقدا للاعتبار والقيمة، منزوع الشعور بالكرامة، مفرَّغا من الأهداف والتطلعات، مشوش الذهن ومشتت التفكير، منفصلا عن الواقع، يسيطر عليه القلق، تتفاعل فيه – كما وصّف د. مصطفي حجازي – عُقد النقص والعار واضطراب الديمومة (4)، يقف عاجزا مسلوب الإرادة إزاء عُنف اعتباطية الطبيعة وغوائلها، وفي مواجهة عُنف المتسلط، يتهدده اختلال التوازن الداخلي بالضياع. وهنا تقدم له السلفية طوق النجاة، بما هي إرث تاريخي تراكمي، من العقائد الدينية والأعراف والتقاليد، المطبوعة في الذاكرة الجمعية للمجتمع المتخلف (المحافظ)، الذي تشكل السلفية نظامه القيميّ و بنيته المعرفية والثقافية.
فمع تراكم الشعور بالإحباط ، وانكماش مساحة الأمل حتى بلوغها نقطة اليأس، وانسداد أفق الحياة، والارتهان للاستلابات، فإنه بدلا من التصدي لما يطرحه الواقع من تهديدات، والتطلع نضاليّا إلى المستقبل، لا يجد الإنسان المقهور والمستلب دينيا، من خيار متاح أمامه في المجتمع المتخلف المحافظ، غير اللجوء إلى ملاذ الماضي الإيماني، متمثلا في الأصولية العقائدية (السلفية)، في محاولة يائسة لاستعادة توازنه الداخلي ورأب صدعه النفسي، ملتمسا راحة البال والعزاء، في التمسك التعويضي – التمذهبي – بالمفاهيم السلفية لفهم النصوص الدينية، على نحو ما أشار إليه إيرِك هوفّر، مِن أنّ بعض هؤلاء الذين يُرعبهم فراغُ نفوسهم، ويُقلقهم انعدامُ غاياتهم، يجدون في الدين خير ملجأ وميدانٍ لسدّ ذلك الفراغ، والقضاء على ذلك الضياع (5)، ذوبانا لهوية الفرد في هوية الجماعة، حيث إن الإنسان المقهور، يجد في السلفية تعويضا عن بؤس الحاضر، من خلال التماهي مع أمجاد الماضي، الذي يتم إخفاء مساوئه الكثيرة، وتضخيم حسناته القليلة، وإضفاء طابع من القداسة على رموزه، وتظهيره أسطوريّاً في أزهى الصور.
إن المجتمع المتخلف، هوبطبيعة بنيته العلائقية والسوسيوثقافية، مجتمع سلفيّ ماضويّ. ولذا فإن نكوص الإنسان المقهور إلى الماضي، والعيش في ملاذه، تماهيا مع المنظومة الفكرية السلفية السائدة، بمختلف أنساقها المعرفية المغلقة (معتقدات، أعراف، تقاليد.. إلخ)، ما هو إلا وسيلة للخروج من المأزق الوجودي واستعادة الاتزان الداخلي واكتساب الاعتبار الذاتي، حيث يشكل الفعل النكوصي أواليةً دفاعية، تعكس الشعور بالدونية، إلى شعور تعويضي بالامتياز والاستعلاء. على نحو ما عبر عنه مصطفي حجازي، بقوله: “التمسك بالتقاليد، واحترام الأعراف، ومراعاة العادات، يُعاش كمصدر للاعتبار الذاتي، نظرا لما يتضمنه من قبول اجتماعي. إن الإنسان المقهور، الذي لا شرف له، يتخذ من تَمثُّل التقاليد والأعراف مصدرا للشرف والاعتبار، يتخذ من قدرته على مراعاة الأعراف السائدة، مصدرا للكبرياء والرضا عن الذات”.
وبقدر ما تكون الاستلابات موغلة في اللاعقلانية وشديدة الوطأة على النفس، يكون التمسك بالسلفية مفْرطا في اللاعقلانية وشديد الانفعالية، حيث يأخذ شكلين رئيسين من الآليات (الميكانيزمات) الدفاعية: أحدهما الرضوخ، الذي تعززه يقينية غيبية، تلغي العقل بما لا يقبل مجرد إعادة التفكير، كالخنوع للاستبداد، قبولا بالمكتوب ونزولا عند (إرادة) القضاء والقدر، والتسليم بالأمر الواقع المفروض من الخارج، على أنه مشيئة الله، والاتكالية، والصبر.. الذي هو (مفتاح الفرَج)، والقناعة.. التي هي (كنز لا يفنى)، والزهد في متع الحياة – التي هي نصيب المتسلط – تعلقا خرافيا بنعيم ما بعد الموت، واستجداء السماء بالأدعية، وما إلى ذلك من أشكال الهروب في أوهام ميتافيزياء التعزية، على نحو ما نلاحظه في تشبع الضمير الجمعي لملايين (الرعايا) الليبيين، بثقافة (الله غالب).
ويبدو ذلك جليا – على سبيل المثال – في الموقف الانكفائي من أزمة نضوب السيولة النقدية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية (المسحوقة) من محدودي الدخل، والتهام التضخم لمدخرات الناس، فإنهم يجوعون وتُنتهك حقوقهم وكراماتهم وأعراضهم، ولا يخرجون في تظاهرة من بضعة آلاف – في مدينة يربو عدد سكانها عن مليونيْ نسمة، من كل الأطياف والأنحاء الليبية – لمجرد الاحتجاج سلميا ضد سياسات الإفقار والتجويع والإذلال! مكتفين باجترار مقولات وأمثال وأدعية الاستسلام والرضوخ، أو المحاولة البائسة للتماهي في النمط الاستهلاكي للطبقة المسيطرة، أو تصريف العدوانية المكبوتة، في صورة عنفٍ لفظيّ بدائيّ، يعبر عن نفسه في الدعاء الساذج على المتسلط، من قبيل: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، لك الله يا ليبيا، الفلوس وسخ دنيا، وين بيهربومن ربي يوم القيامة، صيّورهم تحت الوطا زيّْهم زيّْنا، الله ياخذ فيهم الحق، يلقوه ويتلقوه في صحتهم، انشالّا فَ الداء والدواء.. إلخ”. وفي كتب التراث نجد الكثير جدا من الشواهد السلفية التي تصب في هذا الاتجاه، من قبيل ما نقله الإمام أبو حامد الغزالي (6) عن النبي في أفضلية الجوع: “جاهدوا أنفسكم بالجوع، فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، وإنه ليس مِن عملٍ أحبُّ إلى الله من جوع وعطش”، وقوله في أفضلية الزهد: “إنْ أردتَ أن يحبك الله، فازهد في الدنيا يحبك الله”، ونقرأ في كتب التراث عشرات النصوص (المقدسة)، التي تزيّن الاتكالية، وتؤكد فاعلية سلاح الدعاء، كقول النبي: “اتّقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها – أو بينه – وبين الله حجاب”. (رواه البخاري ومسلم).
على أنه نظرا لأن السلفية هي حالة نكوص جمعي إلى ماضي (السلف الصالح)، فإن الأواليات الدفاعية الرضوخية، التي تتجه بالإنسان المغلوب على أمره، إلى قمع رغباته.. لعدم قدرته على تحقيقها، والاختباء في ملاذ الماضي.. لعجزه عن مواجهة تحديات الحاضر، والهروب من مواجهة الواقع إلى الاعتصام بالغيب، بما هي فكرة الاعتصام بالغيب أدلجة للتمركز الخُوافي حول الذات المهزومة داخليا. وذلك من خلال استبطان الدونية إزاء المتسلط، أوالاستكانة القدرية، أو استيهام التماثل مع ذوي الامتيازات، أو تفريغ العدوانية بالدعاء على الظالم المستبد، لا تكفي وحدها لاستعادة التوازن الداخلي والاعتبار الذاتي، واكتساب الأهمية والشعور بالثقة، والخلاص من القلق الوجودي. فلا تلبث العدوانية الكامنة والمتراكمة، أن تنفجر عنفا يتوجه إلى إلغاء الآخر، بدعوى الدفاع عن الهوية، التي يضفي عليها التعصب الديني طابع القداسة.
وهنا يبرز الشكل البديل – العُنفي – إلى الواجهة كاستجابةٍ أواليةٍ دفاعية، في هيئةِ علاقةٍ دمجية إيمانية، يتماهى بها المؤمن، فكريا وحركيا، مع الجماعة السلفية (الجهادية) أو المنظومة الاجتماعية المتمترسة وراء الشريعة، منطويا على إيمان أعمى منغلق ضد أي حوار عقلاني أو مراجعة فكرية، مفترضا أن معارفه المستمدة من تراثه الديني، هي خلاصة الحكمة الكونية والحقيقة الكلية غير القابلة للنقض، استئناسا بما أجمع عليه السلف، واستقواءً على الآخر – العدو الافتراضي – بنصرة الحركة السلفية وتأييد المجتمع المحافظ المتزمت دينيا، ذلك أن التعصب الديني، يحوّل الدين إلى أيديولوجيا نافية للآخر المختلف، بحيث يصبح القتل ممارسة دينية، ينتفي معها أي شعور إنساني، وتسود حالة من العدوانية الجماعية (الداعشية)، لا ترى – في زمن بحوث وتطبيقات الخلايا الجذعية – أيَّ جُرمٍ في ضرب الرقاب، وبتر الأطراف، والجَلد، والصلب، وإنزال أفظع العقوبات التعزيرية، التي تبلغ أقصى درجة من البشاعة السادية، تصل إلى إلغاء الحق في الحياة حداً، رجما حتى الموت!.
وكما يجد المتحول إلى السلفية في إيمانه الغيبي تعويضا عن الشعور بالخواء واللاجدوى، ويجد في اندماجه بالمجموعة السلفية تعويضا عن الشعور بالضعف والعجز، تجد فيه الحركة السلفية كائنا بشريا مستلب الوعي، مفرّغا من ذاته، كارها لوجوده، ومؤمنا مستعدا للتضحية بنفسه، انتصارا لقضيتها – التي صارت قضيته – المقدسة، في عالم يرونه فاسدا، لا قيمة للحياة فيه، دون تغيير جذري يلتزم بمعاييرهم المعرفية الدينية، في انفجار هستيري للعدوانية ومشاعر الحقد والكراهية، التي تُصوّر الآخر المختلف رمزا للشر ومصدرا لتهديد الهوية، ضمن ثنائية دار الإسلام ودار الحرب، أو فسطاط الإيمان و فسطاط الكفر. ورغم أن رحى حروبها تدور أساسا في مجتمعات لم تكن يوما إلا مسلمة منذ أربعة عشر قرنا! فإنها لا تستثني أحدا، خارج دائرتها الإيمانية، من الشيطنة والتكفير والاستهداف بالإلغاء، ذلك أن السلفية تتجاوز بنظرتها الشمولية الاستبدادية ما هو ديني إلى كل ما هو دنيوي، وأنّ الإيمان الديني لديها يأخذ طابعا أيديولوجيا، نافيا للآخر وغير مقرٍّ له بالحق في الاختلاف، ومنغلقا في بنيته المعرفية على يقينية إطلاقية، بما يُحوّل الإيمان إلى مشروع لإعادة صياغة العالم وفقا لرؤيتها العقائدية.. طوعا أو كرها، حيث تصبح ممارسة العنف باسم الله قيمة إيمانية مطلقة عليا، يتراجع معها أيُّ إقرارٍ – وبالتالي أيُّ احتجاج – بالقيم الإنسانية المشتركة بين البشر.
وفي هذا التوجه العنفي لإلغاء الآخر، تعمد السلفية إلى تبرير توجهها الماضوي، وتعزيز قضية حركتها النكوصية المتسربلة بجلباب الإيمان الديني، باستحضار كل صور التحقق التاريخي للإسلام، في الغزوات الجهادية وحروب (الفتح) والتوسع الامبراطوري للدولة الإسلامية، خلال النصف الثاني من القرن السابع والنصف الأول من القرن الثامن للميلاد، كما دُوّنت أحداثها بأدق التفاصيل التي تختلط فيها الحقيقة بالخيال، في روايات تراثية تحتفي أشد الاحتفاء بالعدوانية الفجة، المبررة بالمقدس، التي تقع في أساس حروب الفتح، وتمجد غزو واحتلال أوطان الشعوب والأمم المختلفة.. باسم الله، وتشرعن ممارسة أقصى درجات العنف، إيغالا في القتل والسبي والنهب، بدعوى إنقاذ البشر – طوعا أو كرها – من الكفر، وإخراجهم (عُنوةً) من الظلمات إلى النور!
كما يبرز الطابع السلفي للعنف، في العودة أربعة عشر قرنا إلى الوراء، لاستدعاء أسماء كبار القادة الغزاة الفاتحين، وإضفاء طابع من القداسة التصنيمية على شخوصهم المندثرة، للاقتداء بأفعالهم وسِيَرهم المؤسطرة، في القرن الواحد والعشرين. وذلك في انتقائية مؤدلجة، تُبرز نموذج عقبة بن نافع، وتخفي نموذج الحجاج بن يوسف الثقفي، رغم أنه لا فرق يُذكر بين النموذجين، ومع أن الأخير كان له أكبر الأثر في تثبيت أركان الدولة الإسلامية. وتبلغ السلفية أقصى درجات قوتها الإقناعية في المحاججة بصحة خياراتها وصوابية منطقها، بالتمترس وراء عشرات النصوص المقدسة – من الكتاب والسنة – المؤسِّسة للعنف، في التأصيل له دينيا، نازعةً عن تلك النصوص صفتها التاريخانية وظرفيتها الزمكانية، بحجة صلاحيتها لكل زمان ومكان. وذلك هو ما يفسر الظهور القوي لتنظيم الدولة الإسلامية، وسرعة تمدده، وانتشاره الواسع، والمَدد المتجدد له من المقاتلين الأشداء الانغماسيين والانتحاريين. وهو ما يفسر تلك المشاهد الصادمة، من صور الممارسات العنفية التي سجلتها عدسات التصوير، لأعضاء التنظيم (السلفي) الإرهابي، في ضرب الرقاب، وحز الرؤوس، وسبي النساء، واغتصاب الأطفال الإناث، وفرض عقائدهم الإيمانية على الإيزيديين والمسيحيين في العراق.. بضميرٍ مرتاح! اقتداءً بسيرة (السلف الصالح). وذلك – أيضا – هو ما يفسر الرعب الشديد، الذي ينتاب أغلب المؤمنين العاديين، لا فرق يُذكر بين الأمي منهم وحامل درجة الدكتوراه، عندما يتم إخضاع النص التراثي للعقل النقدي، فليس من الوارد لديهم إعادة النظر فيما استقر عليه التراث من جمود وخرافية، أو إجراء قراءة عقلانية في النص المقدس، بل قبول محض وتسليم مطلق، خوفا من خسارة التراث السلفي في مواجهة العقل العلميّ، فالعلم بمنطقه الجدلي المتجاوِز، ينفي ما يُدّعَى للنص من احتواء الحقيقة النهائية المطلقة و الانتفاء عن النقد والمفارَقة للتاريخ.
ويقوم الفكر السلفي عموما على أولية النص، الثابت في ظاهره المفهومي، الجامد في ماضويته الزمكانية، ومن ثم سحبه على الحاضر وفرضه على المستقبل، اقتداء بمن يطلق عليهم السلف الصالح (الذي تثبت وقائع التاريخ أنه لم يكن صالحا أبدا)، ثم تيمنا بسيرة التابعين، الذين كانوا في أغلبهم من (الموالي)، والذين كانوا يُظهرون التمسك الشديد بما انتهى إلى علمهم، مما أجمع عليه السابقون من (الصحابة العرب)، حتى يكتسبوا لأنفسهم الأهمية والاعتبار، في إطار الدولة الشمولية القائمة على الإمامة (السلطة الدينية) القرشية، فكانوا بذلك – كما لا زال أحفادهم – ملكيين أكثر من الملك. وبانتهاء عهد التابعين – مع انتهاء الربع الأول من القرن الثاني الهجري – كانت السلفية قد استقرت على الإتِّباع والأخذ بالمأثور عن السلف، ونبذ استقلالية التفكير والاحتكام إلى العقل، خاصة مع تقاطع المصالح بين رجل الدين (الفقيه، المفتي)، ورجل السياسة (الحاكم، وليّ الأمر)، تحت غطاء الدين، بما تقدمه السلفية من تبرير غيبي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الظالمة، في علاقات (التمايز الطبقي)، والأوضاع السياسية الاستبدادية، في ثنائية (المتسلط / المقهور).
ويحرص المستبد المتسلط – وليّ الأمر، ذو الحظوة – المهيمن على السلطة والثروة، على تشجيع الانكفاء إلى ملاذ السلفية، نظرا لما ترسخه السلفية في عقول العوام، من نمط تفكير غيبي، يلغي الشعور بالغبن، ويحُول دون مقاومة الجور، بل ويجعل من الإنسان المستلب دينيّاً.. عدوا لدودا لنفسه، يتبنى دونيته إزاء تفوق المتسلط ، في سياق منظومة الأيديولوجيا السلفية، التي تشرعن امتيازات المتسلط (الحاكم، الغني)، وتؤكد حقه فيما ناله – دون سائر الآخرين – من الجاه والنفوذ والمال، بإرجاع الأمر كله إلى مشيئة الله، وليس إلى سياسات الاستبداد والفساد، حيث يقوم الفكر السلفي بمهمة التأسيس لطاعة وليّ الأمر، برّاً كان أم فاجراً! فالانقسام الطبقي إلى مترفين وجياع، هو بالمنظور السلفي تدبير إلهي بتقسيم الأرزاق بين الناس، وليس خللا اجتماعيا ناجما عن قوانين السوق، التي أطلقها نظام الحكم، بلا ضوابط. والخروج عن طاعة وليّ الأمر، هو خروج عن طاعة الله، كما وثقته شبكة البيّنة السلفية في هذا (الرابط)، من أدلة حُرمة الخروج على الحاكم الظالم والفاسق. وبالرغم من اللاعقلانية الفجة – جملة وتفصيلا – في هذا الطرح السلفي. وبالرغم مما يحمله من طبيعة تاريخية (اقتصادية، اجتماعية، سياسية) لا تليق بكرامة الإنسان في القرن الواحد والعشرين، فإنه ليس أيسر على الفقيه والحاكم من إقناع المؤمنين بتبنيه عقائديا، ليتحولوا من ثم إلى كتلة من التعصب الأعمى، مستعدة للفتك بكل من يتعرض لهذا الزيف بالانتقاد.
ويعتبر الإمام مالك أهم من أسس للسلفية بكتابه الموطأ، فقد كان هذا الفقيه يتخذ مجلسه بالمسجد النبوي في المدينة، ليفتي في أمور الدين بما يرسخ سلطة الإستبداد الأموي، بمرجعية مئات الأحاديث الموضوعة (كحديث السفرجلات في فضل معاوية)، وقد ذاع صيت مالك في المدينة، رغم وجود من هم أعلم وأفقه منه، كأستاذه ربيعة الرأي، ذلك أن خلفاء بني أمية، قدّموا مالكا وأغدقوا عليه الأموال، نظرا لِما وجدوا فيه من مرونة وقابلية للاستخدام، فكان لهم منه ما أرادوه من توظيف الدين في السياسة، بما يوافق هوى الحاكم المستبد، ويوطئ له رقاب الرعية على طاعة وليّ الأمر ” اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك “، ويشرعن سلاح التكفير، لتصفية الخصوم السياسيين، وتبرير غزو أوطان الآخرين (الكفار) وسفك دمائهم (جهاد)، وهتك أعراضهم (سبي النساء)، ونهب أرزاقهم وأموالهم وأملاكهم (غنائم وجزية وخراج)، وترسيخ أركان سلطة الخلافة الأموية.. باسم الدين! . وقد أحاط مالك نفسه بهالة من الطقوسية، لإلقاء الرهبة في روع الناس، وأشاع عن نفسه أن أمه حملت به ثلاث – وقيل أربع – سنوات، فكُلّما جاءها المخاض، كان يرفض النزول، حتى جاءه الملائكة، وأمروه بالنزول إلى الدنيا، كي يُفقِّه الناس في أمور دينهم! (7)، حتى إن مالكا تجاوز الإفتاء للأحياء، إلى إفتاء الأموات من علماء المسلمين، الذين يأتونه في المنام طلبا للعلم! .
وفي مجتمع المدينة، المتمايز اجتماعيا إلى سادة وموالٍ وعبيد، والغارق في الإنحلال بما غمره من سيل الجواري سبايا حروب الفتح، ظل (الإمام) مالك يفتي انتقائيا في الدين، فيؤصل في الفقه للاتباعية والنقل، ويؤصل في التشريع لتطويع عامة الناس وصياغة ضمائرهم على الرضا بدونية أوضاعهم، ويوطد أمر الحكم لبني أمية، قائلا بلزوم طاعة ولاة الأمر الأمويين، إلى أن زالت دولتهم. وبزوال الخلافة الأموية، نقل مالك ولاءه للعلويين، فبايع النفس الزكية على السمع والطاعة، غير أن العباسيين سرعان ما قضوا على ثورة محمد النفس الزكية، وبسطوا سيطرتهم على الحجاز وكأسلافهم الأمويين، أدرك الخلفاء العباسيون، منذ البدء، أهمية اصطناع الفقهاء – فضلا عن أهمية إعمال السيف في الرقاب – لإخضاع (الرعية)، وتأميم الضمير الجمعي لجمهور المسلمين، وتوجيه الرأي العام (إجماع الأمة) لتبني قيم التخلف والرضوخ والخنوع، كالصبر على ظلم السلطان وجوره، وحرمة الخروج على ولي الأمر، والقناعة والرضا بالقسمة والنصيب، وتجنب الجدال في الدين، حتى يستتب الأمر للحكام (الفاسقين الفجرة). وتشاء الظروف أن تخدم مالكا، فلا يقبل الإمام أبو حنيفة أن يمالئ أبا جعفر المنصور – ثاني خلفاء بني العباس – أو أن يعمل له، فيكون مصيره السجن والإغتيال بالسم، ويكون من الطبيعي أن تتجه أنظار الخلافة العباسية إلى (الإمام) مالك.
فعندما أتى أبو جعفر المنصور الحجاز، قادما من مقر الخلافة في بغداد، تأكيدا لبسط السيادة العباسية على كل أطراف الإمبراطورية الإسلامية، ظن الإمام مالك أنه هالك لا محالة، جرّاء ما كان يفتي به لتعزيز سلطة الأمويين، غير أن أبا جعفر كان من الدهاء بحيث استقبل مالكا بالترحاب، وأجلسه – في روايةٍ – على ركبته اليمنى، في إشارة إلى شموله بالرضا والرعاية (أو كما روى أبوقتيبة، نقلا عن مالك نفسه: “فلما دنوتُ منه رحّب بي وقرّب، ثمّ قال: ها هنا إليّ، فأوميتُ للجلوس، فقال: ها هنا، فلم يزل يُدنيني حتّى أجلسني إليه، ولصقتْ ركبتي بركبتَيْه”..)، وطلب منه الإستمرار على طريقته في الإفتاء، لكن لصالح السلطة العباسية الجديدة، وتوجه إلى مالك بقوله: نريد منك أن تكتب لنا كتابا، نوطئ الناس عليه بالسيف وفي صيغة أخرى من الرواية: يُحملون عليه، ونضرب عليه هاماتهم بالسيف، ونقطع طي ظهورهم بالسياط. وفي صيغة ثالثة: والله لئن بقيتُ، لأكتُبنّ قولك كما تُكتب المصاحف، ولأبعثنّ به إلى الآفاق، فلأحمِلهنّم عليه.. إلخ ما تورده كتب التراث عن لقاء مالك بالمنصور، وسبب تأليف وتسمية كتاب الموطأ. وهكذا كان كتاب (الموطأ)، بمختلف نسخه، المدونة عن إملاء مالك. وهو كتاب يجمع بين رواية الحديث والفقه، اعتمد الأخذ بالنص القرآني في دلالته الجامدة والأحاديث المتضاربة المنسوبة للنبي، مع استبعاد العقل والقياس والتأويل. ولعل الصواب لا يجانب المرء، عندما يطابق بين كتاب (الأمير) في الفقه السياسي، الذي أعده ميكيافيلي لاسترضاء لورينزو الثاني من آل مديتشي، وكتاب الموطأ الذي أعده مالك لإسترضاء أبي جعفر المنصور من بني العباس، فيما يتصل بالحكم والعلاقة بين الحاكم والرعية، وتلك هي إحدى أهم مرتكزات الفكر السلفي الإسلامي: شرعنة الإستبداد السلطوي.
وكنتيجة لمناهج التعليم الرسمي (التلقينية)، والتكييف الإجتماعي التقليدي، والصياغة السلفية للعقول والضمائر، لا زال الإمام مالك قابعا في اللاوعي الجمعي لملايين المسلمين (بالوراثة)، ذلك أنّ الأغلبية.. حتى وإن لم يكونوا متدينين، هم في تكوينهم المعرفي، وفي أعماق نفوسهم، وفي ذاكرتهم التاريخية، مسكونون بالتعصب للموروث الثقافي السلفي، الذي نشئوا وتربوا عليه،فما أن يواجه أحدهم فكرا مغايرا لنمط أحاديته الثقافية، حتى تستيقظ الخلية الإرهابية النائمة فيه، ويتحول إلى كتلة من العنف الحاقد، الذي يضغط عليه من الداخل، فيندفع لتفريغه على الخارج، في أشكال شتى من الإرهاب الفكري، ولا يلزمه سوى أن يحمل السيف ويهوي به على الآخر ليزيحه من أمامه، مستعينا بالتكبير والدعاء بأن ينصره الله على الكافرين ويورثه نساءهم وأموالهم وذلك هو جانب من الحقيقة المرعبة للسلفية،بشقيها: الدعوي (الإرهاب الكامن)، والجهادي (الإرهاب النشط).
وكما نظّر (الإمام) مالك في الموطأ للاتباعية والجمود العقائدي، وكما فعل مثله أحمد بن حنبل في المسند، والشافعي في الأم، فقد تبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الذي يعتبر المرجع الرئيس للسلفية والتكفيريين، في التمسك بالنص الجامد.. نقلا عن السلف، ورفض إعمال العقل في فهم النص أو التعاطي عقلانيا مع التراث، بما يتوافق مع معطيات الواقع المتجدد. وهكذا نجد أن السلفية في منطلقاتها العقيدية، تفصل بين الفكر والواقع، ونجد السلفي يرى الكمال المطلق في الماضي، ولا يرى في الإنعتاق من قيود الجمود العقائدي والخروج عن مقولات السلف، سوى انحراف أو زندقة أو إلحاد أو شعوبية، فالفكر السلفي قد استقر على رؤية أن الوجود الإسلامي الحقيقي، هو فيما أجمعت عليه (الأمة)، وأن خلاص الفرد لا يتحقق إلا بالذوبان في الجماعة – بما هي رعية – التي لا تجتمع على باطل، والباطل هو حرية التفكير والإجتهاد بالرأي والإختلاف عما استقر عليه السلف، والباطل عندهم هو التجديد، فكل جديد – بنظر السلفية – هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الكاتب الليبي: محمد ابراهيم بن زكري
الإحالات:
(1) إريك فروم: الإنسان المستلب وآفاق الحرية. ترجمة حميد لشهب.
(2) ريتشارد شاخت: الاغتراب. ترجمة كامل يوسف حسين.
(3) هربرت ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد. ترجمة جورج طرابيشي.
(4) مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي/ مدخل إلى سيكولوجية الانسان المقهور.
(5) Eric Hoffer: The True Believer المؤمن الحقيقي: إيرِك هوفّر (توجد له ترجمة عربية أنجزها غازي القصيبي، بعنوان: المؤمن الصادق).
(6) الإمام أبو حامد الغزالي: مختصر إحياء علوم الدين.
(7) ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ 4 / الأصبهاني: حلية الأولياء جـ 6 / إبن قتيبة: الإمامة و السياسة