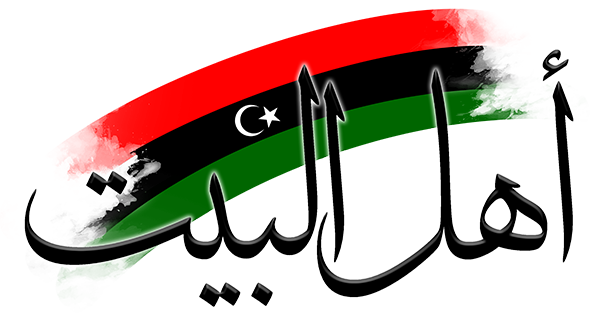الإسلامُ.. محوراً لثقافتنا

تمثل الثقافة في الأمة المنظومة الفكرية التي من خلالها تستطيعأن ترسم الإطار العام لتوجهاته، وتبني كيانها الحضاري المستقل الذي تتميز به، وتصون نفسها من التفسخ والذوبان في الثقافات الأخرى التي ستجعل منها مسخاً تسيطر عليه روح الانهزام والانقياد.
لذلك فإن الثقافة بهذا المعنى يجب أن تُبني على مقومات لها قدرتها في الحفاظ على خصوصية الأمة واستقلالها فكرياً، والناظر في تاريخ الأمة الإسلامية يجدها في مختلف أدوارها ومراحلها قوةً وضعفاً، تحضراً وتخلفاً، حافظت على منظومتها الفكرية من الاختراق، إلى أن اجتاحتها مرحلة الاستعمار وما تلاها بعد ذلك، حيث كانت الثقافة والفكر يدوران على محور الدين “الإسلام”، وكان البناء الفكري الأول الذي يمثل قواعد الأساس للمثقف هو مبادئ العلوم الإسلامية التي من خلالها يتم بناء الشخصية الفكرية للمثقف، وقد ساهم هذا الأمر في اصطباغ مختلف العلوم التي ازدهرت في تاريخ الحضارة الإسلامية بهذه بالصبغة الإسلامية، فلا نكاد نقرأ كتاباً من كتب التراث في أي علم من العلوم إلا وجدنا أثراً لهذه الصبغة فيه، بل إن كتب اللهو والمجون نجد أثر هذه الصبغة فيها، وسبب ذلك أن كل علومنا ومعارفنا على اختلافها كانت تدور على محور فكري أساسه الدين، ومتنه اللغة العربية.
لذلك فإن المسلمين لمّا أن ترجموا علوم غيرهم من الأمم، صبغوا هذه العلوم بصبغتهم، ودمجوها في منظومتهم فصارت كأنها وليدة حضارة الإسلام بما طوّروا وجددوا فيها، وهذا لا ينفي حدوث التأثر بما عند الأمم الأخرى فهو أمر لا تسلم منه الطبيعة البشرية، ولكنه تأثر لم يبلغ أساس البناء الفكري، ولم يؤثر على الهوية الثقافية للأمة، بل عكس مدى رحابتها ومرونتها في احتواء المعارف والفنون، وسعة هامش التنوع والاجتهاد فيها، ويدل على ذلك تراثنا الزاخر بالآراء المختلفة والمناقشات المتنوعة الذي لم تملكه أمة من الأمم.
لقد ظلّت ثقافة الأمة دائرة على محور الإسلام، يحصنها من الاختراق ويضمن لها الحد الأدنى من الاستقلال، ويُؤَمّنها من التبعية والسيطرة إلى أن اجتاحت أوروبا الاستعمارية معظم العالم الإسلامي، وهي تعرف ضرورة اختراق هذه المنظومة الفكرية، وكسر محور ثقافتها ليسهل عليها أن تسيطر على هذه الأمة وتجد منها الانقياد والخضوع، وقد نجحت في ذلك حيث أوجدت في منظومتنا الفكرية محاور متعددة تدور عليها ثقافتنا، من قومية واشتراكية وعلمانية وتقدمية، مما أدى لإضعاف محور الإسلام الذي كان يمثل الأساس للبنية المعرفية للمثقف، وصار المثقف فاقداً لأي حصانة، منهزماً أمام ثقافة الغرب منبهراً بحضارته، يتلقى أفكاره بالإجلال والإكبار، ويتلقف مناهجه ليحاكم بها علوم الإسلام والشريعة، ولم تسلم الآداب والفنون من الاصطباغ بالهوية الغربية فأنتجت الطبقة المثقفة في عمومها مسوخاً مشوهة من الإنتاج الغربي لم تلامس الناس ولا وجدوا فيها رسالة يفهمونها أو يدركون مرماها، فاتسعت الهوة بين هذه الطبقة النخبوية وبين عموم الناس، ولازلنا إلى اليوم نعاني من آثار هذا الاختراق الذي عكس حالةً من التيه والضياع لمنظومة الأمة الفكرية، وخلّف لنا ثقافة غير منتجة، إنما تعيد في الغالب تدوير منتجات الثقافات الأخرى بجودة سيئة ومستوىً رديء.
إن النهوض بالأمة يستلزم بناء منظومتها الفكرية على أساسها المتين المتمثل في دينها، وهذا بلا شك يحتاج إلى إعادة صياغة الخطاب الديني المتسامي عن العصبية المذهبية والمتمسك بأصولها الثابتة، والنقي من اللوثة الغربية، خطاب مبني على إدراك جيداً للواقع يلبي احتياجاته ويعي متغيراته، خطاب يلتزم بأصول الدين وأركانه، ويجدد في وسائله وأدواته، وهذا الأمر يوجب على المهمومين بالعمل الإسلامي تجاوز حقول الدعوة إلى مرحلة بناء طبقة مثقفة وفق منظومة إسلامية رصينة يتم إحلالها محل هذه النخب المثقفة العاجزة، ولن يكون ذلك إلا بالخطاب الديني المشار إليه آنفاً والذي يجب أن تصاغ به أدوات الفكر ، وفي أولها مناهج التعليم ووسائل الإعلام وسبل الدعوة، ومن خلاله تنتج الآداب والفنون.
على أن كل هذا لا يلزم منه القطيعة مع ما عند الآخرين من معارف وآداب وفنون، فإن أغلب المعارف والعلوم والآداب مشاع للإنسانية تتعاطاه الأمم فيما بينها، على أن يمرّ كل وافد من الأمم الأخرى من خلال المنظومة الفكرية التي تنفي عنه الخبث والشوائب وتنقيه من كل جرثومة قد تزرع في جسد الأمة داء يستفحل فيها ويستعصي شفاؤه.
بقلم: علي أبوزيد
مصراتة – ليبيا